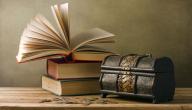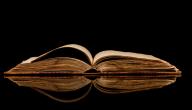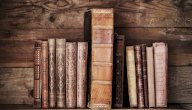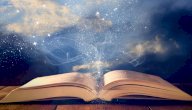أمثلة على التّمييز من القرآن
ما معنى أنَّ التّمييز يُفسّر مُبهماً قبله؟
- قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}[١]، شهرًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، ونوع هذا التّمييز تمييز مفرد أو تمييز ذات؛ لأنّه يُفسّرُ مبهمًا قبله، فدائمًا المعدود بعد الأعداد من "11" وحتّى "99" يُعربُ تمييزًا.[٢]
- قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}[٣]، نعجة: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، فكلمة نعجة جاءت بعد العدد "99" فهي تمييز، نوعه مُفرد لأنّه فسّر مُبهمًا قبله.[٤]
- قوله تعالى: {إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}[٥]، كوكبًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مفرد، إذ فسّر مُبهمًا قبله وجاء بعد عدد من الأعداد التي يأتي بعدها تمييز.[٦]
- قوله تعالى: {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[٧]، مرّة: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مفرد، جاء بعد العددِ "70" ففسّر ما كان مُبهمًا.[٦]
- قوله تعالى: {أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وأعز نفرًا}[٨]، مالًا: تمييزمنصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييزُ جملة ويُسمّى أيضًا تمييز نسبة لأنّه محوّل، وفي هذا الشّاهد هو تمييز مُحوّل عن مُبتدأ، فأصلُ الجملة: مالي أكثر من مالك، نفرًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أيضًا هو تمييز محوّل والتّقدير: نفري أعزّ من نفرك.[٤]
- قوله تعالى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا}[٩]، شيبًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة محوّلٌ عن فاعلٍ، فأصلُ الجملةِ: واشعلَ شيبُ الرّأس.[٤]
- قوله تعالى: {'وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا}[١٠]، عيونًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظّاهر على آخره، ونوعه تمييز جملة لأنّهُ مُحوّلٌ، فهو في هذا الموضعِ تمييز محوّل عن مفعول به، وأصلُ الجملةِ: وفجّرنا عيون الأرض.[١١]
- قوله تعالى: {وَلَوْجِئنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا}[١٢]، مددًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظّاهر على آخره، وهو تمييز مُفرد لمجيئه بعد كلمة "مثل" وهو ما أجري مجرى المقادير.[١١]
- قوله تعالى: {فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا}[١٣]، ذهبًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتحة الظّاهر على آخره، وهو تمييز مُفرد لمجيئه بعد ما يشبه أسماء الكيل وهو "ملء".[١٤]
التّمييزُُ يكونُ اسمًا جامدًا، فضلة، نكرة، وظيفته أنّه يُفسّرُ شيئًا مُبهمًا قبله، وبذكره تصبحُ الجملة واضحةً مفهومة، لا يأتي إلّا منصوبًا، وينقسـمُ إلى قسمين: تمييز ذات، وتمييز جملة، ومفتاحه أنّنا نستطيعُ تقدير حرف الجرّ "من" قبله، مثال: اشتريت أربعة عشر قلمًا، إن قدّرنا: اشتريتُ أربعة عشر من الأقلام، فالمعنى يصحّ وبهذا نستطيع أن نستهدي إلى معرفة التّمييز.[١٥]
أمثلة على التّمييز من الشعر
هل يتأخّر التّمييز عن مميّزه وما حكمه؟
- قال الشّاعر عنترة في معلّقته:
فيها اثنتان وأربعون حلوبةً
- سُودًا كخافيةِ الغُرابِ الأسحمِ
حلوبة: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز ذات، لمجيئه بعد العدد "42" وقد فسّر مبهمًا قبله.[١٦]
- قال الشّاعر أبو تمّام:
السّيف أصدق أنباءً من الكتبِ
- في حدّه الحدُّ بين الجدّ واللعبِ
أنباءً: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة بعد صيغة التّفضل "أفعل" ويكثر التّمييز بعد صيغة التّفضل "أفعل".[١٧]
- قال شاعر:
عد النّفس نُعمى بعد بؤساك ذاكرًا
- كذا وكذا لطفًا به نُسي الجَهدُ
لطفًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مُفرد منصوب بعد "كذا".[١٤]
- قال الشّاعرُ جرير:
ألستُم خيرَ مَنْ ركبَ المطايا
- وأندى العالمين بطون راح
بطون: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة بعد صيغة التّفضل "أفعل" ويكثر التّمييز بعد صيغة التّفضل "أفعل".[١٦]
- قال شاعرٌ:
أنفسًا تطيبُ بنيلِ المنى
- وداعي المنون يُنادي جهارا
نفسًا: تمييزمنصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز نسبة وقد تقدّم على عامله "تطيب" وهو نادر، يتقدّم إن كان عامله فعلاً متصرّفاً؛ أي: أتطيبُ بنيل المنى نفسًا؟ وهو تمييزٌ مُنقلبُ عن فاعلٍ؛ فأصله: أتطيبُ نفسُك؟ وفي غير هذه الحالة يمتنع تقدّم العامل.[١٨]
- يقول الشّاعر رشيد بن شهاب اليشكري:
رأيتُك لمّا أن عرفتَ وجوهنا
- صددتِ وطبتَ النّفسَ يا قيسُ بن عمرو
النّفس: تمييز منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة، وجاء التمييز في هذا الشّاهد معرّفاً بـ "أل" لكنّها معرفة في اللفظ، نكرة في معناها، لذلك تكون أل في الكلمة زائدة.[١٩]
التّمييز يأتي نكرة، وإن جاء معرّفاً فهي معرفة لفظيّة، ولا يتقدّم تمييز الذّات على عامله البتّة، أمّا تمييز الذّات فتقدّمه نادر إن كان العاملُ فعلاً مُتصرّفاً، أمّا في ما عدا ذلك فهو ممتنعٌ، ولكن يجوزُ أن يتوسّطَ التمييز بين العامل "الفعل" وبين مرفوعه، مثال: زكا أصلًا مُحمّد، وقد يُحذفُ التّمييز إن كان معلومًا من الكلامِ في نحو: كم عمرك؟ والتّقدير: كم سنةً[٢٠].
جمل على التّمييز
كيف يأتي التمييز في الجمل؟
- هذا لترٌ حليبًا: حليبًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مفرد فسّر مُبهمًا قبله، فكل ما أتى بعد الكيل وما يشبهه يُعربُ تمييزًا.[٢]
- باع العطّارُ غرامين عطرًا: عطرًا تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره وهو تمييزُ مُفرد؛ فسّر مُبهمًا قبله، وأتى بعد وزن، فما يأتي بعد وزن يُعربُ تمييزًا.[٦]
- ورثتُ أمتارًا أرضًا: أرضًا: تمييز منصوب، وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مُفرد فسّر مُبهمًا قبله، وأتى بعد مساحة، فنعربه تمييزًا منصوبًا.[٢]
- أعطني ذراعًا كتّانًًا: كتّانًًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييزٌ مفردٌ فسّر مُبهمًا قبله، ونعربه تمييزًا؛ لأنّه أتى بعد ما دلّ على المقياس[٦]
- اشتريتُ ثلاثة عشر كتابًا: كتابًا: تمييز منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز مُفرد، فسّر مُبهمًا قبله وأتى بعد عددٍ، وما أتى بعد الأعداد من "11 حتّى 99" يُعربُ تمييزًا.[٢١]
- رسمتُ اثنتا عشرة لوحة: لوحة: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييزٌ مُفرد فسّر مبهمًا قبله، وأتى بعد عدد "12"، فنعربه تمييزًا.[٢١]
- ازداد زيدٌ أدبًا: أدبًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة محوّل عن فاعل، فأصلُ الجملة: ازداد أدبُ زيد.[٢١]
- غرست الحديقة شجرًا: شجرًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييزُ جملة محوّل عن مفعول به، فأصلُ الجملة: غرستُ شجر الحديقة[٢١]
- خالدٌ أوفرُ عقلًا منك: عقلًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييزُ جملة محوّل عن مُبتدأ، فأصلُ الجملة: عقل خالد أوفرُ من عقلك.[١٦]
- رأيتُ كذا رجلًا: رجلًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتى التّمييز بعد كلمة "كذا" وهو من المواضعِ الّتي يكثر فيه استعمال التّمييز.[٦]
- نعم خالدٌ عالمًا: عالمًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتى التّمييز في أسلوب المدح "نِعْم" وهو من المواضع التي يكثر فيها استعمال التّمييز.[٦]
- بئس الطالبُ خالدًا: خالدًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتى التّمييز في أسلوبِ الذّم "بِئس" وهو من المواضع التي يكثر فيه استعمال التّمييز[٦]
- امتلأت مكتبتي كتبًا: كتبًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتّى التّمييز بعد فعل امتلاء، ويكثر مَجيء التمييز بعد أفعال الامتلاء وما أشبهها، مثل: ملأت قلب والدي سرورًا، غصّت المدينة عمالًا، ازدحم الطّريق أناسًا، أشبع العمّالُ المدينة نظافة، ازداد زيد علمًا.[١٩]
- ما أكرمُ زيدًا خلقًا: خلقًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتى التّمييز بعد أسلوب التّعجب، ويكثر مجيء التّمييز بعد التّعجّب أو ما دلّ عليه.[١٩]
- لله درّه فارسًا: فارسًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وأيضًا في هذا المثالِ أتى بعد صيغة تعجُّب سماعيّ.[١٨]
- أنت أعلى منزلةً: منزلة: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، ويكثر التّمييز بعد اسم التّفضيل "أعلى".[١٩]
- كفى بك معصيةً ألا تطيعَ والديك: معصية: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة ويكثر استعماله بعد الفعل كفى.[١٩]
- هذه فتاةٌ كالصّباحِ جمالًا: جمالًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة، ويكثر استعمال التّمييز بعد أدوات التّشبيه.[٦]
- عمتم صباحًا: صباحًا: تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، وهو تمييز جملة، يكثر استعاله في مثل هذا التّركيب، وبعضهم أجاز إعرابها مفعولًا فيه ظرف زمان، أي: أنعموا في الصّباحِ، وأيضًا يُشبه هذا التّركيبِ قولنا: أنعم بالًا، أو عموا ظلامًا.[٦]
- خالدٌ حسن وجهًا: وجهًا: تمييز منصوب وعلامةُ نصبه تنوين الفتح الظّاهر على آخره، أتى بعد الصّفة المُشبّهة "حسن"، ويكثر مَجيء التّمييز بعد الصّفة المُشبّهة.[٦]
يأتي التمييز على نوعين؛ تمييز ذات وهو الّذي يأتي بعد الأعداد من (11-99)، أو بعد المقاديرِ من كيلٍ أو وزنٍ أو مساحة أو بعد ما يُشبه المقادير، أمّا تمييزُ الجملةِ هو الّذي يأتي إمّا تمييزًا محوّلاً أو غير محوّل، فالمحوّل إمّا عن فاعلٍ أو عن مبتدأ أو عن مفعول به، وغير المُحوّل في مثلِ ما ذُكر من مواضع، ومن خلال ما تقدّم نستنتج أنّ التّمييزَ لا يأتي جملة ولا شبه جملة.[٢٢]
لقراءة المزيد من أمثلة التمييز، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: أمثلة على تمييز النسبة.
المراجع[+]
- ↑ سورة التوبة، آية:36
- ^ أ ب ت محمد زرقان الفرخ، الواضح في القواعد والإعراب، صفحة 263. بتصرّف.
- ↑ سورة ص، آية:23
- ^ أ ب ت سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، صفحة 282. بتصرّف.
- ↑ سورة يوسف، آية:4
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر محمد زرقان الفرخ، الواضح في القواعد والإعراب (الطبعة 1)، صفحة 272. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية:80
- ↑ سورة الكهف، آية:34
- ↑ سورة مريم، آية:4
- ↑ سورة القمر، آية:12
- ^ أ ب مصطفى الغلايني، جامع الدّروس العربية، صفحة 568. بتصرّف.
- ↑ سورة الكهف، آية:109
- ↑ سورة آل عمران، آية:91
- ^ أ ب محمد خير الحلواني، النحو الميسر، صفحة 519. بتصرّف.
- ↑ محمد زرقان الفرخ، الواضح في القواعد والإعراب، صفحة 275. بتصرّف.
- ^ أ ب ت سعيد الأفغاني (2011)، الموجز في قواعدِ اللغة العربية (الطبعة 1)، دمشق-سورية:دار الثقافة والتراث، صفحة 287.
- ↑ سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربيّة، صفحة 288. بتصرّف.
- ^ أ ب عاصم بيطار (1981)، النّحو والصّرف، صفحة 214.
- ^ أ ب ت ث ج عاصم بيطار (1981)، النحو والصرف، صفحة 215.
- ↑ جمال الدين الأنصاري (2012)، قطر الندى وبل الصدى (الطبعة 4)، دمشق- حلبوني:دار الفجر، صفحة 353. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث أحمد سليم الحمصي، محمد أحمد قاسم، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (الطبعة 1)، طرابلس- لبنان:منشورات دار جروس، صفحة 344. بتصرّف.
- ↑ محمد علي سلطاني (2015)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (الطبعة 1)، سورية-دمشق:دار العصماء، صفحة 85، جزء 3. بتصرّف.