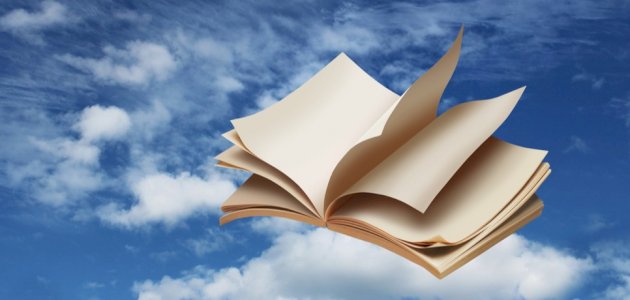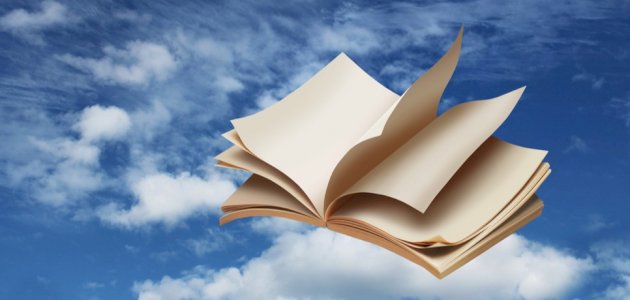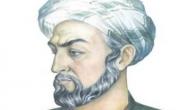محتويات
صاحب قصيدة مدارس آيات
مَن هو دعبل الخزاعي؟
صاحب القصيدة هو دعبل الخزاعي، وهو أحد شعراء العصر العباسي المعروفين ويُطلق عليه لقب أبو علي، وتعود أصول هذا الشاعر إلى الكوفة، واشتُهر بغرض الهجاء، ذكر النّقاد أنّ شعره يقع في مرتبة الجودة وله الكثير من الأخبار المتناثرة في بطون الكتب، أقام دعبل الخزاعي في بغداد وقد كان صديقًا للبحتري في تلك الآونة، وقد صنّف كتابًا في طبقات الشعراء[١]، وهو أكبر شاعر شيعي بعد الشاعر السيد الحميري وهو من الدعاة العلويين البارزين وجهر كثيرًا بقوله ضد خلفاء بني العباس.[٢]
ذكر ابن خلكان في ترجمته لدعبل الخزاعي أنَّه كان مولعًا بغرض الهجاء وهواه الحطّ من أقدار النَّاس، وقد وصفه ببذاءة اللسان ولم يترك أحدًا إلا وقد هجاه، ومِن بين مَن طالتهم شرارة لسانه هارون الرشيد، وكذلك الأمين والمأمون من بعده ومن ثم الواثق والمعتصم، وقد كان طويل العمر، وذكر مرة أنَّه قال إني أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين عامًا لا أجد مَن يصلبني عليها، وقد توفّاه الله في بلدة يُقال لها اسم الطيب وهي ما بين الواسط وخوزستان، وترك من بعده أشعارًا متفرقة جمعها الأدباء في ديوان له.[١]
شرح قصيدة مدارس آيات
ماذا أراد الشاعر أن يوصل من معان في قصيدته؟
عمل مًن جاء بعد دعبل على شرح تائيّته في كتب ومصنفات، وأمَّا تفصيل معانيها ففيما يلي:
مَدارِسُ آياتٍ خَلَت مِن تِلاوَةٍ
- وَمَنزِلُ وَحيٍ مُقفِرُ العَرَصاتِ
لِآلِ رَسولِ اللَهِ بِالخَيفِ مِن مِنىً
- وَبِالرُكنِ وَالتَعريفِ وَالجَمَراتِ
المدارس هي اسم لموضع، ويُشير الشاعر في بداية قصيدته إلى أنَّ المواضع التي نزلت بها آيات القرآن الكريم الآن هي خالية من القُرَّاء وخالية من رجال الدين، والمكان الذي لطالما نزل به الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بات خاليًا الآن لا أحد فيه ممن يُعتدّ به ويُنسب له الفضل والخير من الأمور.
دِيارُ عَلِيٍّ وَالحُسَينِ وَجَعفَرٍ
- وَحَمزَةَ وَالسُجّادِ ذي الثَفِناتِ
يستعرض هنا الشاعر الرموز التي يُؤمن بها، فيذكر رؤوس الأسماء الذين هم أحق بالخلافة من بني أمية -برأيه- وهم علي بن أبي طالب وابنه الحسين -رضي الله عنهما-، وفي جعفر قولان إما جعفر بن محمد الصادق أو جعفر بن أبي الطالب الملقب بالطيار، وحمزة بن عبد المطلب والسَّجاد هو ابن الحسين بن علي، والمعروف عندهم بذي الثفنات أي الرجل الذي خشنت لديه مواضع السجود.
دِيارٌ عَفاها جَورُ كُلِّ مُنابِذٍ
- وَلَم تَعفُ لِلأَيّامِ وَالسَنَواتِ
قِفا نَسأَلِ الدارَ الَّتي خَفَّ أَهلُها
- مَتى عَهدُها بِالصَومِ وَالصَلَواتِ
وَأَينَ الأُلى شَطَّت بِهِم غَربَةُ النَوى
- أَفانينَ في الآفاقِ مُفتَرِقاتِ
يذكر الشَّاعر أنَّ ديار آل البيت محيت بسبب المخالفين لآل البيت، وهي لم تُنح بسبب طول العهد وبُعد الزّمان، ثم يقف مرة أخرى متحسرًا على آل البيت وهو يُسائل الدار عن صلواتهم وصيامهم، ويتساءل أيضًا عن أهل هذه الديار الذين تفرقوا في البلاد وقُتّلوا بها وهم كأغصان الشجر الصغيرة، فافترقوا فرقة لم يجتمعوا بعدها أبدًا.
هُمُ أَهلُ ميراثِ النَبِيِّ إِذا اِعتَزَوا
- وَهُم خَيرُ قاداتٍ وَخَيرُ حُماةِ
فهؤلاء الذين تفرقوا في البلاد هم خير السّادة وهم الذين يتصلون بنسبهم إلىرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم حتّى وارثوه، فهو يذكر أحفاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وَما الناسُ إِلّا حاسِدٌ وَمُكَذِّبٌ
- وَمُضطَغِنٌ ذو إِحنَةٍ وَتِراتِ
إِذا ذَكَروا قَتلى بِبَدرٍ وَخَيبَرٍ
- وَيَومِ حُنَينٍ أَسبَلوا العَبَراتِ
وَكَيفَ يُحِبّونَ النَبِيَّ وَأَهلَهُ
- وَقَد تَرَكوا أَحشاءَهُم وَغراتِ
وكلّ الناس الباقين هم الذين يحسدون أولئك السّادات على صلتهم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهؤلاء نفسهم هم الذين إذا ذُكر أمامهم قتلى المشركين على يد الصحابة -رضوان الله عليهم- يوم خيبر أو حنين بكوا عليهم وحزنوا؛ لأنّهم من أقاربهم، فكيف يجمعون هذا التناقض في صدورهم.
لَقَد لايَنوهُ في المَقالِ وَأَضمَروا
- قُلوبًا عَلى الأَحقادِ مُنطَوِياتِ
فهؤلاء كلهم -على حدّ وصف الشاعر- ممن لم يكونوا مؤمنين حقًّا، ولكنّهم كانوا منافقين يُبطنون الكفر ويُظهرون الإيمان، ولم يكن إيمانهم سوى طمع بالمغانم وخوفًا من شوكة المسلمين.
قُبورٌ بِكوفانٍ وَأُخرى بِطَيبَةٍ
- وَأُخرى بِفَخٍّ نالَها صَلَواتي
وَقَبرٌ بِأَرضِ الجَوزَجانِ مَحَلُّهُ
- وَقَبرٌ بِباخَمرا لَدى العَرِماتِ
وَقَبرٌ بِبَغدادٍ لِنَفسٍ زَكِيَّةٍ
- تَضَمَّنَها الرَحمَنُ في الغُرُفاتِ
وَقَبرٌ بِطوسٍ يا لَها مِن مُصيبَةٍ
- تُرَدَّدُ بَينِ الصَدرِ وَالحَجَباتِ
يحكي الشاعر في هذه الأبيات التي اتحدّت في موضوعها عن تفرق قبور آل البيت في المناطق المختلفة بعد أن خرجوا من المدينة المنورة إلى الكوفة مع الحسين بن علي -رضي الله عنه-، وكوفان هي اسم من أسماء الكوفة ممنوع من الصرف مثل اسم عثمان، وهي فيها قبر الحسين رضوان الله عليه، والمقصود بالقبر الذي في بغداد هو قبر الكاظم.
فَأَمّا المُمَضّاتُ الَّتي لَستُ بالِغًا
- مَبالِغَها مِنّي بِكُنهِ صِفاتِ
إِلى الحَشرِ حَتّى يَبعَثَ اللَهُ قائِمًا
- يُفَرِّجُ مِنها الهَمَّ وَالكَرَباتِ
نُفوسٌ لَدى النَهرَينِ مِن أَرضِ كَربَلا
- مُعَرَّسُهُم مِنها بِشَطٍّ فُراتِ
يذكر الشاعر في هذه الأبيات موقعة كربلاء التي حصلت لما قتل فيها الحسين بن علي -رضي الله عنه- وهو يبكيه، وكيف كانت القتلى على طرفي النهر في كربلاء، وقد مُنعوا من شرب الماء في نهر الفرات، وهو يخاف على نفسه من الهلاك إن هو زار تلك القبور الطاهرة.
أَخافُ بِأَن أَزدارَهُم وَيَشوقُني
- مُعَرَّسُهُم بِالجِزعِ مِن نَخَلاتِ
تَقَسَّمَهُم رَيبِ الزَمانِ فَما تَرى
- لَهُم عَقوَةً مَغشِيَّةَ الحُجُراتِ
سِوى أَنَّ مِنهُم بِالمَدينَةِ عُصبَةً
- مَدى الدَهرِ أَنضاءً مِنَ الأَزَماتِ
وكأنّ الزمان قد تقاسمهم وهجرهم وقتلهم في البلاد، فلا ترى في حجرة من الحجرات الخاصة بهم نفس يتردد وكأنّها كلها خاوية على عروشها لم يطأها من قبل إنسان، فلا يُرى لهم مسكنٌ بعد أن كانت بيوتهم مهبطًاللوحي، ولم ينجُ من مجزرة آل البيت إلا بضع منهم كانوا في المدينة وقد انسلوا من تلك المجزرة كما ينسلّ السيف من غمده.
قَليلَةُ زُوارٍ سِوى بَعضِ زُوَّرٍ
- مِنَ الضَبعِ وَالعِقبانِ وَالرَخَماتِ
لَهُم كُلَّ حينٍ نَومَةٌ بِمَضاجِعٍ
- لَهُم في نَواحي الأَرضِ مُختَلِفاتِ
ولا يزور أولئك المطهّرون من آل البيت سوى الأعداء الذين يُشبهون الضباع والعقبان في هيئاتهم، وقد تفرقوا بالأرض وقتلوهم فكأنّ كل مكان على هذه الأرض صار قبرًا لهم، وفي ذلك تكمن الإشارة إلى الغربة التي عاشوها.
وَقَد كانَ مِنهُم بِالحِجازِ وَأَهلِها
- مَغاويرُ نَحّارونَ في السَنَواتِ
تَنكَّبُ لَأواءُ السِنينَ جِوارَهُم
- فَلا تَصطَليهِم جَمرَةُ الجَمَراتِ
حِمىً لَم تُطِرهُ المُبدِياتُ وَأَوجُهٌ
- تَضيءُ مِنَ الايسارِ في الظُلُماتِ
وهو في هذه الأبيات يُمجّد كرم آل البيت وبني هاشم لمّا كانوا في الحجاز وتحلّ الأزمات بالنَّاس يأتون ويُساعدونهم، فجور السنين وظلمها لا يصل إليهم، وكأنّ حماهم في الحجاز مثل العرين لا تزوره المذنبات، فبياض وجوههم مأخوذ من خلوّ آل البيت من الذنب والعار.
إِذا أَورَدوا خَيلًا تَسَعَّرُ بِالقَنا
- مَساعِرُ جَمرِ المَوتِ وَالغَمَراتِ
وَإِن فَخَروا يَومًا أَتَوا بِمُحَمَّدٍ
- وَجِبريلَ وَالفُرقانِ ذي السوراتِ
يذكر الشاعر في هذين البيتين مناقب آل البيت وصفاتهم الحميدة، فهم في القتال لا أحد يقدر عليهم ولا عدو ينمكّن منهم، وإن أرادوا يومًا أن يفخروا فإنّ فخرهم ظاهر في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك جبريل -عليه السلام- وهو الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
أولَئِكَ لا مِن شَيخُ هِندٍ وَتِربِها
- سُمَيةَ مِن نَوكى وَمِن قَذِراتِ
مَلامَكَ في أَهلِ النَبِيِّ فَإِنَّهُم
- أَحِبّايَ ما عاشوا وَأَهلُ ثِقاتي
سَأَقصُرُ نَفسي جاهِدًا عَن جِدالِهِم
- كَفاني ما أَلقى مِنَ العَبَراتِ
يقع هنا الشاعر في الحديث عن اثنتين من النساء وهما: هند بنت عتبة -رضي الله عنها- وهي التي أسلمت في فتح مكة، وسمية أم زياد، ويقع في أبنائهن وسلالتهنّ من أمثال معاوية -رضي الله عنه-، ثمّ يقول لعاذليه في حبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله ألّا يعذلوه فهو سيبقى على حبّهم ولن يُجادلهم في ذلك، فتكفيه العبرات التي يذرفها على آل البيت.
فَيا نَفسُ طيبي ثُمَّ يا نَفسُ أَبشِري
- فَغَيرُ بَعيدٍ كُلُّ ما هُوَ آتِ
وَلا تَجزَعي مِن مُدَّةِ الجَورِ إِنَّني
- كَأَنّي بِها قَد آذَنَت بِبَتاتِ
فَإِن قَرَّبَ الرَحمَنُ مِن تِلكَ مُدَّتي
- وَأَخَّرَ مِن عُمري لِيَومِ وَفاتي
شَفَيتُ وَلَم أَترُك لِنَفسِيَ غُصَّةً
- وَرَوَّيتُ مِنهُم مُنصُلي وَقَناتي
يُحاول الشَّاعر أن يُسلّي نفسه مرة أخرى ويُصبّرها على ما حلّ بآل البيت، ويتوعّد نفسه أنَّ الظلم الذي حلّ بآل البيت سينتهي وها قد حان وقت القصاص، فلو أمدّ الله تعالى في عمره فإنَّه سيشفي نفسه منهم بقتلهم بسيفه ورمحه حتى تعود الأمور إلى موازينها ويُحقّ الحق.
عَسى اللَهُ أَن يَأوي لِذا الخَلقِ إِنَّهُ
- إِلى كُلِّ قَومٍ دائِمُ اللَحَظاتِ
أُحاوِلُ نَقلَ الشَمسِ مِن مُستَقَرِّها
- وَإِسماعَ أَحجارٍ مِنَ الصَلِداتِ
وهو يدعو ربه في البيت الأوّل ويسأله أن يرحم الخلق ويخرج المهدي المنتظر ويملأ الأرض بالعدل بعد أن ملأها النّاس بالظلم، وهو لن يقدم على جدالهم مرة أخرى؛ لأنَّ جدال معارضيه هو أشبه بنقل الشمس من مكانها ومحاولة إسماع الحجر عظيم القسوة الأصم.
فَمِن عارِفٍ لَم يَنتَفِع وَمُعانِدٍ
- يَميلُ مَعَ الأَهواءِ وَالشَهَواتِ
قُصارايَ مِنهُم أَن أَأوبَ بِغُصَّةٍ
- تَرَدَّدُ بَينَ الصَدرِ واللَهواتِ
إِذا قُلتُ عُرفًا أَنكَروهُ بِمُنكَرٍ
- وَغَطّوا عَلى التَحقيقِ بِالشُبُهاتِ
كَأَنَّكَ بِالأَضلاعِ قَد ضاقَ رُحبُها
- لِما ضُمِّنَت مِن شِدَّةِ الزَفَراتِ
يُكمل الشاعر في هذه الأبيات حديثه عن حال مُعارضيه، فهم موزعون ما بين عارفٍ للأمور تلك ولكنّه لم ينتفع بمعرفتها، وما بين رجلٍ معاندٍ للحقائق ويُحاول أن يُغطي على الأمور الحقيقيّة الثابتة بالشبهات، لذلك هو لن يُقدم على نقاشهم بل سيكتفي بالزفرات التي تملأ صدره وكأنّ صدره يضيق بها حتّى يكاد أن ينفجر.
معاني المفردات في قصيدة مدارس آيات
ما الكلمات الغريبة التي تضمنتها قصيدة مدارس آيات؟
من أبرز الكلمات الغريبة التي وردت في القصيدة:
- العرَصات: هي الجمع من المفرد عرصة، ومعناها ساحة الدار الواسعة التي لا يكون فيها بناء.[٣]
- الثفنات: أي المكان الذي تعرض للخشونة أو اليباس من شدة العمل به.[٤]
- أفانين: ومعناها الغصون التي تلتف حول بعضها البعض، ويُقال أفانين الكلام أي: أساليبه.[٥]
- معرسهم: المعرس هو المكان الذي يأوي إليه المسافر آخر الليل فينزل فيه.[٦]
- الغمرات: وهي الجمع من الغمر ومعناه الحسد العظيم وكذلك هو الحقد الدفين.[٧]
- المنصل: وهي مأخوذة من النصل ومعناها السكين الحادة أو الرمح شديد القوة أو هو السهم.[٨]
الأفكار الرئيسة في قصيدة مدارس آيات
ما الأفكار التي ناقشها الخزاعي في مدارس آيات؟
من أهم الأفكار التي ناقشها الشاعر في قصيدته:
- الوقوف والتأسي على آل البيت والحزن على ديارهم الدارسة.
- المقارنة بين آل البيت وغيرهم من النَّاس.
- وصف بعض النّاس بالنفاق وبيان حزنهم على قتل أقربائهم المشركين.
- الحزن على قبور آل البيت الموزعة في أصقاع الأرض.
- تذكر حادثة كربلاء.
- مدح آل البيت وذكر مناقبهم الحسنة.
- الابتعاد عن جدال من لا يوافقون الشاعر في الفكر والعقيدة.
- توعد بني أمية وغيرهم بالأخذ بثأر آل البيت منهم.
- تكرير ذكر الابتعاد عن مناقشة معارضية فكريًا وعقائديًّا.
الصور الفنية في قصيدة مدارس آيات
ما أبرز الصور التي نسجها دعبل في تائيّته؟
ومن أبرز الصور التي زيّنت تائية دعبل الخزاعي:
- وَأَينَ الأُلى شَطَّت بِهِم غَربَةُ النَوى
- أَفانينَ في الآفاقِ مُفتَرِقاتِ
الصورة الفنية في هذا البيت الشعري هي استعارة تصريحية عندما قال أفانين، وهو يقصد آل البيت فحذف المشبه وهو آل البيت وأبقى على المشبه به وهو الأفانين.
- تَقَسَّمَهُم رَيبِ الزَمانِ فَما تَرى
- لَهُم عَقوَةً مَغشِيَّةَ الحُجُراتِ
الصورة الفنية في هذا البيت هي استعارة مكنية فقد تمّ استعارة التقسيم للزمان وهي صفة خاصة بالإنسان، وذلك من أجل توضيح المعنى والبلاغة في التصوير.
- قَليلَةُ زُوّارٍ سِوى بَعضِ زُوَّرٍ
- مِنَ الضَبعِ وَالعِقبانِ وَالرَخَماتِ
تكمن الصورة الفنية في هذا البيت في الشطر الثاني من القصيدة وهي استعارة تصريحية، حيث حذف المشبه وهو الشخص المراد وترك المشبه به وهو الضبع والعقبان والرخمات.
- وَقَد كانَ مِنهُم بِالحِجازِ وَأَهلِها
- مَغاويرُ نَحّارونَ في السَنَواتِ
الصورة الفنية هي في الشطر الثاني من البيت وهي استعارة تصريحية، فقد حذف المشبه وصُرّح بالمشبه به فقط وهو المغاوير.
- شَفَيتُ وَلَم أَترُك لِنَفسِيَ غُصَّةً
- وَرَوَّيتُ مِنهُم مُنصُلي وَقَناتي
تكمن الصورة هنا في الشطر الثاني من البيت، وهي "رويت منهم" وهنا الاستعارة هي استعارة مكنية حذف فيها المشبه به وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه وهي "رويت".
المراجع[+]
- ^ أ ب "دعبل الخزاعي"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ حربي الشلبي، تائية دعبل الخزاعي، صفحة 2. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى عرصات في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى الثفنات في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى أفانين في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى مُعَرَّسُهُم في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى الغمرات في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.
- ↑ "تعريف و معنى المنصل في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 17/4/2021. بتصرّف.