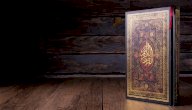محتويات
ما هو المد؟
تعريف المد
المد في اللغة هو الزيادة، وأمّا المد في الاصطلاح؛ فهو إطالة زمن النطق بحرف المد أو الحرف اللين.[١]
حروف المد
حروف المد ثلاثة، هي:[١]
- الألف الساكنة التي قبلها مفتوح، مثل: (جَاء).
- الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل: (يَقُول).
- الياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل: (قِيل).
حروف اللين
حرفا اللين هما:[١]
- الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل: (خَوف).
- الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل: (الخير).
وللمد أنواعٌ عديدةٌ، شرحها فيما يأتي.
المدّ الطبيعي
تعريف المدّ الطبيعي
هو المد الذي تقوم به ذات الحرف وبه يستقيم المعنى؛ أي أنّه موجودٌ في ذات الحروف ولا يتوقف على سبب كالسكون أو الهمزة،[٢]وسمّي بالطبيعي؛ لأنّ الإنسان ذو الطبع السليم لا يزيده عن حده ولا ينقصه، ومن أسمائه أيضًا المد الأصلي؛ لأنّه أصل جميع المدود، والمد الطبعي أي الفطري؛ لأنّ الزيادة التي فيه يدركها الإنسان فطريًا وذاتيًا، وزمن أو مقدار مدّه: حركتان.[٣]
أمثلة على المد الطبيعي
من أمثلة المد الطبيعي:[٢]نوع المد الطبيعي
|
مثاله
|
الألف الساكنة المفتوح ما قبلها
|
(صبَّار)، (قَال)، (الكتَاب).
|
الياء الساكنة المكسور ما قبلها
|
(يأتِي)، (قدِير)، (أمِين).
|
الواو الساكنة المضموم ما قبلها
|
(رسُول)، (غفُور)، (وقُود).
|
المدّ الفرعيّ
هو المد الذي يُطال فيه الصوت بأحد حروف المد زيادة على المد الطبيعي لسبب جاء بعده كالهمزة أو السكون وينعدم بانعدام هذا السبب،[٤] وسمّي فرعيًا لتفرعه عن المد الطبيعي، ومن أسمائه المد المزيدي لزيادة مده عن الطبيعي،[٥]وللمد الفرعي سببان، هما:[٦]
- ما يتوقف على الهمزة: مثل المد المتّصل، والمفصل، ومد الصلة.
- ما يتوقّف على السكون: مثل المد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين.
وفيما يأتي بيان أنواع المد الفرعي.
المدّ المتّصل
هو أن يتبع حرف المدّ مباشرةً همزةٌ في كلمة واحدة، سواء أكانت الهمزة في آخر الكلمة أو في وسطها، وحكم مده الوجوب، أما مقداره وصلًا ووقفًا أربع حركات توسطًا أو خمس حركات فوق التوسط،[7] ومن أمثلة المدّ المتّصل:
- (الصَّائِمِينَ)؛[٧] حيث جاء حرف المد الألف بعده الهمزة في كلمةٍ واحدة.[٨]
- (جَاءَ)؛[٩] أتى حرف المد الألف بعده همزة في نفس الكلمة.[٨]
- (سوء)؛[١٠] حيث جاء حرف المد الواو بعده همزة في نفس الكلمة.
المدّ المنفصل
أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة ثم يتبعه في أول الكلمة التي تليه همزة، وسمّي منفصلًا؛ لأنّ سبب المد وهو الهمز جاء منفصلًا عن حرف المد، ومن أسمائه مد حرف بحرف ومد كلمة بكلمة ومد البسط، ويُمد جوازًا بمقدار أربع أو خمس حركات، وللمد المنفصل نوعان:[13]
- المنفصل الحقيقي: وهو ثبوت حرف المد في الكلمة لفظًا ورسمًا مثل: (قُوا أَنفُسَكُمْ)؛ حرف المد الألف وبعده الهمزة في كلمة منفصلة.
- المنفصل الحكمي: وهو ثبوت حرف المد لفظًا لا رسمًا مثل: (يَأيُّها)، (هَٰؤُلَاءِ)، (هَأَنتُمْ)، وفي هذا النوع لا يجوز الوقوف على الجزء الأول من الكلمة؛ لأنّها في الرسم القرآني كلمة واحدة فلا تُفصل.
ومن أمثلة على المد المنفصل:
- (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ)؛[١١] حيث جاءت الألف في "بما" بعدها الهمزة في "أُنزل".[١٢]
- (قالُوا أَنُؤْمِنُ)؛[١٣] حيث جاءت الألف في "قالوا" بعدها الهمزة في "أنؤمن".[١٢]
- (وَفِي أَنْفُسِكُمْ)؛[١٤] حيث جاءت الياء في "وفي" بعدها الهمزة في "أنفسكم".[١٢]
- (وَجَآءُوا أَبَاهُمْ)؛[١٥] حيث جاءت الألف في "جاؤوا" وبعدها الهمزة في "أباهم".[١٦]
مدّ البدل
وتعريف مد البدل؛ هو أن تسبق الهمزةُ حرفَ المد في كلمة، ولا يكون بعد حرف المد همزةٌ أو سكون، ويكون حرف المد فيها مبدلًا عن همزة، أما إذا لم يكن مبدلًا عن همزة؛ فيسمّى المد الشبيه بالبدل، ويمد جوازًا بمقدار حركتان،[19] ومن الأمثلة عليه:
- (ءَادَم).[١٧][١٦]
- (إيمَانًا).[١٨][١٦]
- (أُوتُوا).[١٩][١٦]
- (لَيَئُوس).[٢٠][١٦]
- (وَبَاءُو).[٢١][٢٢]
- (مَئَابٍ).[٢٣][٢٢]
المدّ اللازم
هو أن يأتي بعد أحد حروف المد أو اللين سكون أصلي في كلمة أو في حرف من حروف فواتح السور في الوقف أو الوصل، وسمّي لازمًا بسبب لزوم سببه وصلًا ووقفًا، ولأنّ جميع القراء اتفقوا على مده ومقداره، ومقدار مده ست حركات،[٢٤]ويُقسم المد اللازم إلى قسمين:[٢٥]
القسم الأول: المدّ اللازم الكملي، وهو نوعان:[٢٥]
- المدّ اللازم الكلمي المثقّل: وهو ما كان فيه الحرف الساكن الذي بعد حرف المد مدغمًا فيما بعده في كلمة واحدة.
- المدّ اللازم الكملي المخفف: وهو ما كان فيه الحرف الساكن الذي بعد حرف المد غير مدغم في ما بعده في كلمة واحدة.
القسم الثاني: المد اللازم الحرفي: وهو ما يتعلق بالحروف في بدايات السور، ومجموع الحروف التي تمد مدًا لازمًا منها سبعة حروف مجموعة في كلمة "نقص عسلكم"، وهو نوعان:[٢٥]
- المدّ اللازم الحرفي المثقّل: أن يكون الحرف الساكن الذي بعد حرف المد هجاؤه على ثلاثة أحرف ومدغمًا فيما بعده.
- المدّ اللازم الحرفي المخفف: أن يكون الحرف الساكن الذي بعد حرف المد أو حرف اللين غير مدغم فيما بعده.
وفيما يأتي أمثلة على المدّ اللازم بقسميه:
- المدّ اللازم الكلمي المثقّل: (الضَّالِّينَ)، (الْحَاقَّةُ)، (أَتُحَجُّونِّى)؛ ففي هذه الأمثلة جاء حرف المد متبوعًا بحرف ساكن أدغم في الحرف الذي بعده.[٢٦]
- المدّ اللازم الكلمي المخفف: ومثالها الوحيد في القرآن كلمة (ءآلئن).[٢٦]
- المدّ اللازم الحرفي المثقّل: حرف الميم في (الٓمٓ)، وحرف السين في (طسم).[٢٧]
- المدّ اللازم الحرفي المخفف: (صٓ)، (نٓ)، (عسق) مع مراعاة حكم الإخفاء عند القراءة بين نون السين والقاف.[%5Bobject%20Object%5D [29]]
المدّ العارض للسكون
وهو أن يأتي في آخر الكلمة بعد حرف المد حرفٌ متحرك ثم يسكن عند الوقف عليه؛ لذا سُمي عارضًا للسكون؛ لأنّه سكن بالوقف عليه فالسكون فيه عارض وليس أصلي، وللمدّ العارض للسكون أنواع هي:[30]
- المدّ العارض للسكون المطلق: وهذا النوع يكون مدًا طبيعيًا حال وصله فيما بعده أما عند الوقف يكون مدًا عارضًا للسكون، ويمد جوازًا بقدار حركتين أو أربعة أو ستة، ومثاله: (تَعلَمُون)، (ومُؤمِنين)، (الحِسَاب).[٢٨]
- المدّ العارض للسكون الذي أصله المدّ المتصل: فهو يكون عند الوصل مدًا ومتصلاً وعند الوقف مدًا عارضًا للسكون ويمد وجوبًا أربع أو خمس حركات، أو جوازًا ست حركات، ومثاله: (السَّمَاء).[٢٨]
- المدّ العارض للسكون الذي أصله البدل: فيكون نوعه عند الوصل مد بدل وعند الوقت مدًا عارضًا للسكون، ويمد جوازًا حركتين أو أربعة أو ست حركات، ومثاله: (مَئَابٍ).[٢٨]
- المدّ العارض للسكون الذي أصله اللين: ومثاله (خَوف).[٢٨]
المدود الملحقة في التجويد
مدّ العوض
وهو إبدال التنوين المفتوح ألفًا عند الوقف، ومقدار مده حركتان وجوبًا، ويُستثنى من هذا التاء المربوطة؛ فإنّها تبدل هاءً حال الوقف، ويبدل التنوين المفتوح بألف في الصور التالية:[٢٩]
- الصورة الأولى: أن يكون حرف المد مرسومًا مثل: (حكيمًا).
- الصورة الثانية: أن يكون حرف المد غير مرسوم مثل: (سَوَاءً) ، (نِدَاءً).
- الصورة الثالثة: أن يكون نون توكيد خفيفة مرسومة تنوينًا: (وَلَيَكنُونًا) ، (لنَسفَعًا).
ومن أمثلة مد العوض:
مدّ التمكين
وهو نوع من أنواع المدّ الطبيعي الكلمي، ويكون عند التقاء واو مدية مع واو متحركة، أو التقاء ياء مدية مع ياء متحركة، ومقدار مده حركتان، ولمدّ التمكين ثلاث صور:[٣٥]
- الصورة الأولى: أن تأتي الياء المدية بعد ياء مشدّدة مسكورة فعندها يجب تمكين المد.
- الصورة الثانية: أن تأتي واو متحركة بعد واو مدية أو ياء متحركة بعد ياء مدية وهنا لا بدّ من تمكين المد لئلا يدغم أو يسقط حرف المد فيما بعده.
- الصورة الثالثة: أن تأتي واو مضمومة بعدها واو مدية أو ياء مكسورة بعدها ياء مدية.
ومن أمثلة على مد التمكين:[٣٥]
- (حُيِّيتُمْ).[٣٦]
- {آمَنُوا وَعَمِلُوا}.[٣٧]
- (فِي يَوْمَيْنِ).[٣٨]
- (يَلْوُونَ).[٣٩]
- (يُحْيِي وَيُمِيتُ).[٤٠]
مدّ اللين
وهو عبارة عن مدّ حرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وسمّي حرفا اللين بهذا الاسم؛ لأنّ نطقهما وخروجهما من الفم يكون من دون كلفة،[44] ويحدث مد اللين عند الوقف على الحرف المتحرك الذي يلي حرف اللين والذي يسكن بسبب الوقف ويصبح حكمه كالعارض للسكون؛ فيمد حركتين أو أربعة أو ستة، أما عند الوصل فلا يمدّان ولا بد من قصرهما فينطقان كنطق الحرف الصحيح، ومن أمثلة مدّ الل[٤١]
مدّ الفرق
وهو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل في الاسم، واستبدال همزة الوصل بحرف مد، ويعد من أنواع المد اللازم بسبب سكون الحرف الذي يلي حرف المد، ويحدث مدّ الفرق عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم أوله لام التعريف، وعندها تبدل همزة لام التعريف إلى ألف مدية ليفرق بين الاستفهام والخبر؛ إذ إنّ اللفظ دون الاستبدال يكون متشابهًا، وعمومًا عند التقاء همزة قطع مع همزة وصل يجوز أحد هذين الوجهين:[٤٦]
- الوجه الأول: إشباعه؛ أي مده بمقدار ستة حركات وهو الأولى عند الأداء.
- الوجه الثاني: تسهيل همزة الوصل، أي نطقها بحالة بين همزة محقّقة وحرف مدّ.
وتقتصر أمثلة مد الفرق في القرآن على هذه الكلمات الثلاثة التي لم يرد غيرها فيه:
- (آلذَّكَرَيْنِ): إذ وردت مرتين في سورة الأنعام.[٤٧][٤٦]
- (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ): إذ وردت مرة في سورة النمل ومرة في سورة يونس.[٤٨][٤٦]
- (ءآلْآنَ): إذ وردت مرتين في سورة يونس.[٤٩][٤٦]
مدّ الصلة الكبرى
هو أن تقع هاء الكناية الزائدة المضمومة أو المكسورة الدالّة على المفرد المذكر الغائب بعد حرف متحرك في كلمة وقبل همزة قطع متحركة، مما يؤدي إلى إشباع حركتها؛ فيتولد عن الضمة حرف واو مدّي، ويتولد عن الكسرة ياء مدّية، ويمدان بمقدار خمس أو أربع حركات، ويعد هذا النوع فرعًا عن المد المنفصل،[٥٠]ولا بد لحدوث مد الصلة الكبرى أن تقع آخر الكلمة بعد حرف متحرك وبعدها همزة قطع متحركة، ويستثنى من ذلك هذه الحالة في القرآن: (فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ)؛ فتقرأ الهاء هنا بالسكون وصلًا ووقفًا، ويسمى سكون الصلة الكبرى،[٥١]ومن أمثلة على مد الصلة الكبرى:
- (يَرَهُ أَحَدٌ).[٥٢][٥٣]
- (مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا).[٥٤][٥٣]
- (إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن).[٥٥][٥١]
- (هَذِهِ أَنْعَام).[٥٦][٥١]
مدّ الصلة الصغرى
هو أن تقع هاء الكناية الزائدة المضمومة أو المكسورة الدالّة على المفرد المذكر الغائب بين حرفين متحركين مثل: (إِنَّهُ كَانَ)، و(بِعِبَادِهِ خَبِيرًا)، ممّا يؤدي إلى إشباع حركتها، فيتولد عن الضمة حرف واو مدي، ويتولد عن الكسرة ياء مدية، وسمّي بمد الصلة؛ لأنّه يُمدّ فقط في حال الوصل، ولأنّ الهاء توصل بواو أو ياء مدية،[54] ولا بد لحدوث مد الصلة الصغرى أن تقع هاء الكناية بين متحركين، ويُستثنى من ذلك بعض الحالات في القرآن وهي:[٥١]
- الحالة الأولى: (أَرْجِهْ وَأَخَاهُ)، في سورة الأعراف، فالهاء هنا تقرأ ساكنةً وصلًا ووقفًا؛ لذلك تسمّى سكون الصلة الصغرى؛ لأنّ الأصل صلة هذه الهاء.
- الحالة الثانية: (يَرْضَهُ لَكُمْ)، في سورة الزمر، وهذه تقرأ بالقصر أي فقط بمقدار حركة الضم دون صلة، ويسمّى قصر الصلة الصغرى.
ومن أمثلة على مد الصلة الصغرى:[٥١]
- (إنَّ رَبَّهُۥ كَانَ).[٥٧]
- (بِهِۦ بَصِيرًا).[٥٨]
- (وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).[٥٩]
- (فَيُضَعِفَهُۥ لَهُ)ۥٓ.[٦٠]
مراتب المدود
مراتب المدود من الموضوعات المهمة في علم التجويد، وتختلف مراتب المدود بين القوة والضعف، وهذا يرجع إلى اختلاف أسبابها، ويمكن تحديد مرتبة المد رجوعًا إلى مقدار المد وعدد حركات المد، وهذا بحسب جميع القراءات العشرة للقرآن، فيتبين أنّ أقواها المد اللازم؛ فإنّه يمد ست حركات، ويليه المد المتصل الذي يمد أربع أو خمس أو ست حركات، ثم المد العارض للسكون الذي يمد حركتين أو أربعة أو ستة، ويليه المنفصل الذي يمد حركتين أو أربعة أو خمسة، ويليه البدل الذي يمد حركتين أو أربعة أو ستة.[65]
ماذا يترتب على اجتماع سببين للمد؟
يترتب على مراتب المدود ما يلي عند تلاوة القرآن:[٦١]
- إذا اجتمع سببان للمد في حرف واحد؛ فعندها يُعمل بالأقوى منهما، ومثال ذلك: كلمة (ءآمِّينَ)، فيها مد بدل ومد لازم؛ فيمد اللازم لأنّه الأقوى.
- إذا اجتمع مدان من نفس النوع متصلين أو منفصلين في الكلمة فلا بد من التسوية بينهما في المد، فإذا مد الأول خمس حركات فالثاني لا بد أن يمد بنفس المقدار.
- إذا اجتمع مد متصل ومد منفصل ولم تكن همزة المتصل متطرفةً؛ فلا بد من التسوية في مقدار المد بينهما أيضًا فإذا مد الأول أربع حركات يمد الثاني أربع حركات أيضًا.
- إذا اجتمع مع المتصل متصل آخر، وكانت همزة الثاني متطرفةً ومد الأول أربع حركات، فلا بد من مد الثاني أربع أو ست حركات، وإذا مد الأول خمس حركات فلا بد من مد الثاني خمس أو ست حركات.
- إذا اجتمع منفصل مع متصل وكانت همزة المتصل متطرفةً جازت الحالات نفسها التي في النقطة السابقة.
- إذا اجتمع مد منفصل أو متصل مع مد عارض للسكون ومد الأول أربع حركات أو خمس حركات؛ فيمد العارض في كلا الحالتين حركتين أو أربعة أو خمسة.
- إذا اجتمع المد العارض واللين؛ فإذا مد العارض حركتين مد اللين حركتين، وإذا مد العارض أربع حركات يمد اللين حركتين أو أربع، وإذا مد العارض ست حركات فيمد اللين ست حركات أو أربعة أو اثنتين.
المراجع[+]
- ^ أ ب ت أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون. (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 161-162. بتصرّف.
- ^ أ ب فريال العبد، كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن، صفحة 171. بتصرّف.
- ↑ أحمد شكري، محمد المجال، وأحمد القضاة، وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 164. بتصرّف.
- ↑ فريال العبد، كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن، صفحة 176. بتصرّف.
- ↑ عبد الفتاح المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، صفحة 276. بتصرّف.
- ↑ أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 168. بتصرّف.
- ↑ سورة الأحزاب، آية:35
- ^ أ ب طه مقلد، كتاب فن الإلقاء، صفحة 85. بتصرّف.
- ↑ سورة الصافات، آية:84
- ↑ سورة البقرة، آية:49
- ↑ سورة البقرة، آية:4
- ^ أ ب ت على الله أبو الوفا، كتاب القول السديد في علم التجويد، صفحة 101. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:13
- ↑ سورة الذاريات، آية:21
- ↑ سورة يوسف، آية:16
- ^ أ ب ت ث ج أحمد شكري، ومحمد المجالي، أحمدالقضاة وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 171. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:31
- ↑ سورة آل عمران، آية:173
- ↑ سورة البقرة، آية:101
- ↑ سورة هود، آية:9
- ↑ سورة البقرة، آية:61
- ^ أ ب أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 172-173. بتصرّف.
- ↑ سورة الرعد، آية:29
- ↑ د, أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 175-177-178. بتصرّف.
- ^ أ ب ت أحمد شكري، محمد المجالي،أحمد القضاة وآخرون، المنير في أحكام التجويد، صفحة 175. بتصرّف.
- ^ أ ب أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون (40)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 175. بتصرّف.
- ↑ أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون (2013)، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 178. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون. (2013)، المنير في أحكام التجويد. (الطبعة 40)، صفحة 179-180. بتصرّف.
- ↑ أحمد شكري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 165. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:23
- ^ أ ب ت ث مجهول الناشر، كتاب المختصر المفيد في أحكام التجويد، صفحة 618. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:23
- ↑ سورة النساء، آية:148
- ↑ سورة النساء، آية:148
- ^ أ ب أحمد شكري، محمد المجالي، محمد القضاة وآخرون، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 167.
- ↑ سورة النساء، آية:86
- ↑ سورة البقرة، آية:25
- ↑ سورة البقرة، آية:203
- ↑ سورة آل عمران، آية:78
- ↑ سورة التوبة، آية:116
- ↑ أحمد شكري، محمد المجالي، محمد سليمان وآخرون، المنير في أحكام التجويد، صفحة 181-180. بتصرّف.
- ↑ سورة الجاثية، آية:7
- ↑ سورة النساء، آية:32
- ↑ سورة الفتح، آية:12
- ↑ سورة المائدة، آية:69
- ^ أ ب ت ث أحمد شكري، عمر حماد، علي الجيوسي وآخرون، المنير في أحكام التجويد، صفحة 176. بتصرّف.
- ↑ سورة الأنعام، آية:143
- ↑ سورة يونس، آية:59
- ↑ سورة يونس، آية:91
- ↑ أحمد خيري، محمد المجالي، أحمد القضاة وآخرون، المنير في أحكام التجويد (الطبعة 40)، صفحة 181-182-183. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج أحمد شكري، محمد المجالي، مأمون الشمالي وآخرون، المنير في أحكام التجويد، صفحة 183-182. بتصرّف.
- ↑ سورة البلد، آية:7
- ^ أ ب أحمد الحفيان، كتاب الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم، صفحة 62. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:255
- ↑ سورة النساء، آية:92
- ↑ سورة الأنعام، آية:138
- ↑ سورة الانشقاق، آية:15
- ↑ سورة الانشقاق، آية:15
- ↑ سورة التوبة، آية:105
- ↑ سورة الحديد، آية:11
- ↑ أحمد المجالي، أحمد القضاة، محمد المجالي وآخرون، المنير في أحكام التجويد، صفحة 184. بتصرّف.
 ملخص المقال
ملخص المقال
المد في اللغة يعني الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة زمن النطق بحرف المد أو اللين، وحروف المد هي الألف، الواو، والياء الساكنة، وأما أنواع المد فأولها: المد الطبيعي وهو المد الذي لا يتوقف على سبب كالسكون أو الهمزة، ويمد بمقدار حركتين، والمد الفرعي والذي يرجع لأحد سببين: الهمزة أو السكون، وله أنواع مثل المد المتصل الذي يأتي فيه حرف المد بعده همزة في نفس الكلمة، والمنفصل الذي يأتي فيه حرف المد بعده همزة في كلمتين منفصلتين، والمد اللازم الذي يأتي بعد حرف المد سكون أصلي ويُسم إلى كلمي وحرفي، والمد العارض للسكون الذي يحدث عند الوقف على حرف متحرك، وهناك أنواعٌ ملحقة بالمدود في التجويد، وهي: مد العوض، التمكين، اللين، الفرق، الصلة الكبرى والصغرى.
 أسئلة شائعة
أسئلة شائعة
يمكن إيجاز أنواع المدود في القرآن الكريم أو في علم التجويد بالآتي:
- المد الطبيعي.
- المد المتصل.
- المد المنفصل.
- مد البدل.
- المد العارض للسكون.
- المد اللازم.
- مد اللين.
- مد العوض.
- مد الصلة.
حكم المد الطبيعي هو نطق حرف المد؛ أي الألف أو الواو أو الياء بشكل طبيعي بمقدار حركتين، ولا يزيد عن حركتين.
أقصى حركات المد أو ما يُعرف بالإشباع هو المد بمقدار ست حركات، وذلك في المد اللازم والمد المتصل.