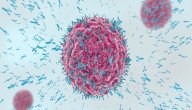محتويات
الأجسام المضادة
يشير مصطلح الأجسام المضادّة إلى أنواع البروتينات التي يتمّ إفرازها من جهاز المناعة في جسم الإنسان، حيث تُسمّى هذه البروتينات أيضًا بالمضادّات المناعيّة، وذلك لأنّ إفرازها من قبل جهاز المناعة يتمّ عند تعرّض الجسم إلى مادّةٍ يتمّ تمييزها على أنّها جسمٌ غريبٌ من قبل جهاز المناعة، وتُسمّى هذه المادّة الغريبٌة بمولّدات المُضاد، حيث تعمل الخلايا المناعيّة على تحفيز سلسلةٍ من ردود الفعل المناعيّة والتي تنتهي بالتصاق هذه الأجسام المضادّة بالمادّة فور تعرّف الجسم عليها على أنّها مادّةٌ غريبة، وتهدف هذه العمليّة إلى التخلّص من هذه المواد وإخراجها من الجسم، ونتيجةً لتعرّض الجسم للعديد من المواد التي تعمل على تحفيز الجهاز المناعيّ والتي تُصنّف على أنّها مولّدات المُضاد فإنّه يتمّ إنتاج أنواعً متعدّدة ومختلفة من الأجسام المضادّة بحيث يصبح الجسم قادرًا على التخلّص من هذه المادّة الغريبة فور دخولها إلى الجسم مرةً أخرى .[١]
للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك قراءة المقال الآتي: ما هي الأجسام المضادة .
تركيب الأجسام المضادة
بشكلٍ عام فإنّ هناك مجموعةٌ متعدّدةٌ من أنواع الأجسام المُضادّة بحيث تختلف هذه الأجسام في تركيبها الدقيق بين نوعٍ وآخرٍ، وبالرغم من وجود اختلافٍ في تركيب هذه الأجسام المُضادّة إلا أنّ هناك بعض الأجزاء الرئيسة التي تتواجد في معظم أنواع الأجسام المُضادّة، وهناك أجزاءٌ أخرى تتواجد في بعض الأنواع ولا تتواجد في البعض الآخر، وفي ما يأتي سيتمّ استعراض كلًا من الأجزاء الرئيسة المكوّنة لها، والأجزاء الثانوية التي قد تختلف من جسمٍ مضادٍ إلى آخرٍ:[٢]
الأجزاء الرئيسة المشتركة
تتواجد هذه الأجزاء الرئيسة المشتركة بين جميع أنواع الأجسام المُضادّة باختلاف نوعها، ومن أهم هذه الأجزاء الأساسيّة والرئيسة ما يأتي:
- سلاسل الأحماض الأمينيّة: إذ إنّ جميع أنواع الأجسام المُضادّة تحتوي على أربع سلاسل من الأحماض الأمينيّة التي تختلف في تركيبها من نوعٍ إلى آخر، فهناك السلاسل الخفيفة التي تتكوّن من مجموعةٍ أقلّ عددًا من الأحماض الأمينيّة المتواجدة في السلاسل الثقيلة، وتتكوّن جميع الأجسام المُضادّة من سلسلتين خفيفتين من هذه الأحماض، وسلسلتين أخرتين من السلاسل الثقيلة.
- الروابط ثنائيّة الكبريتيد: تتكوّن سلاسل الأحماض الأمينيّة من مجموعةٍ من هذه الأحماض التي ترتبط في ما بينها بروابط كيميائية ثنائيّة الكبريتيتد في داخل هذه السلسلة، أما بالنسبة لارتباط كلًا من السلاسل الخفيفة والسلاسل الثقيلة مع بعضها البعض فإنّه يُمكن أن ترتبط بروابط ثنائيّة السلفيد أو ليست روابط تساهميّة، وتختلف الأجسام المُضادّة في ما بينها باختلاف عدد الروابط، إذ إنّ هناك بعض أنواع هذه الأجسام المُضادّة تحتوي على روابط ثنائيّة الكبريتيد أكثر من غيرها ويعود الأمر في ذلك إلى اختلاف التركيب والأحماض الأمينيّة المتواجدة فيها.
- منطقة المفصل: تُسمّى هذه المنطقة بالمنطقة المفصليّة وذلك لأنّها تتميّز بمرونةٍ عاليةٍ نسبيًا في تلك المنطقة، وتُعدّ هذه المنطقة التي يحدث فيها التقاءٌ للسلاسل المختلفة من الأحماض الأمينيّة، ويُشكّل التقائها عند هذه النقطة المفصليّة شكلًا يشبه حرف Y باللغة الإنجليزيّة.
- النطاقات ثلاثيّة الأبعاد: حيث إنّ ترتيب الأحماض الأمينيّة في هذه السلاسل ليست مرتّبة بشكلٍ مسطّحٍ أو مستوٍ، إذ إنّ لها ترتيبٌ ثلاثيّ الأبعاد، حيث تُطوى هذه السلاسل بشكلٍ تلقائيّ وتترتّب بحيث تكوّن تجمّعاتٍ من هذه الأحماض الأمينيّة التي تشكّل في ما بينها أي في المنطقة الداخليّة للشكل ثلاثيّ الأبعاد بين هذه الأحماض الأمينيّة روابط كيميائيّةً تحافظ على هذا الترتيب والشكل ثلاثيّ الأبعاد، وتتكون هذه الروابط من روابط ثنائيّة الكبريتيد تجمعها في ما بينها.
- السكّريات المتعدّدة: يتميّز هذا الجزء بأنّه يحتوي على مجموعةٍ مرتبطة من السكريات التي تشكّل سلسلةً منها إلا أنّ ما يميّزها هو إنّها ليست بالسلاسل الطويلة، بل تُعدّ قصيرةً نسبيًا.
الأجزاء الثانويّة التي لا تتواجد في جميع الأجسام المُضادّة
بشكلٍ عام فإنّه بالإضافة إلى الأجزاء الرئيسة التي تتواجد في جميع أنواع الأجسام المُضادّة أو التي تمّت مناقشتها سابقًا فإنّه من المهم معرفته أنّ هناك مجموعة من الأجزاء التي لا تُعدّ أجزاءً رئيسةً ولا يُشترط وجودها في جميع أنواع الأجسام المُضادّ، إذ إنّها لا تُعدّ أساسيّةً في عمل جميع الأجسام المُضادّة، ومن أهم هذه الأجزاء ما يأتي:
- مناطق التحديد المتكاملة أو مناطق التحديد المتغيّرة: تُعدّ هذه الأجزاء من أهمّ المناطق التي تميّز أنواع الأجسام المُضادّة في ما بينها، إذ إنّها تتكوّن من متسلسلاتٍ مختلفة من الأحماض الأمينيّة والتي تكوّن بدورها مناطق الارتباط التي تميّز أيّ جسمٍ مضادٍ عن الآخر، أي إنّ الأجسام المُضادّة التي تحمل مناطق تحديدٍ متماثلة ومتطابقة تمامًا فإنّها تُعدّ أجسامٌ مضادّة متطابقة وتعمل على الارتباط بنفس أنواع مولّدات المُضادّات.
- منطقة إطار العمل: تُمثّل هذه المنطقة الأجزاء التي تتواجد ما بين مناطق التحديد المتكاملة أو المتغيّرة في ما بينها، حيث يتمّ تقسيم أنواع الأجسام المُضادّة إلى مجموعاتٍ فرعيّةٍ اعتمادًا على مقدار التشابه والاختلاف في الأحماض الأمينية والسلاسل المكوّنة لهذه المناطق.
ما هي أنواع الأجسام المضادة؟
يتمّ تقسيم الأجسام المُضادّة إلى مجموعةٍ من الأنواع المختلفة في ما بينها، حيث يتمّ تقسيمها اعتمادًا على الاختلافات في ما بينها من حيث كلٍ من التركيب الكيميائيّ، والخصائص الفيزيوكيميائيّة، إضافةً إلى خصائصها المناعيّة التي تختلف أيضًا من نوعٍ إلى آخر وتُعدّ حجر الأساس في الاختلافات فيما بينها، ومن أهم الأنواع المتعدّدة لهذه الأجسام المُضادّة ما يأتي:[٣]
الجسم المُضاد من نوع IgG
يتميّز هذا النوع من الأجسام المُضادّة بأنّه يشكّل نسبةً كبيرةً والغالبيّة العظمى من الأجسام المُضادّة، إذ إنّ ما نسبته ثمانون بالمائة من هذه الأجسام المُضادّة تنتمي إلى هذه المجموعة، حيث تتميّز هذه الأجسام المُضادّة أنّه يتمّ إفرازها عند التعرّض الثاني للمادّة الغريبة أو التي تحفّز ردّ الفعل المناعيّ، ويتمّ إنتاجها وإفرازها من قبل خلايا البلازما، كما إنّها تتميّز بأنّها تستطيع عبور المشيمة، أي إنّها تنتقل من الأم الحامل إلى جنينها.
الجسم المُضاد من نوع IgM
حيث تتميّز الأجسام المُضادّة من هذا النوع بأنّه يتمّ إفرازها وإنتاجها من قبل جهاز المناعة عند تعرّض الجسم لأوّل مرةٍ للمادّة الغريبة التي تُسمّى مولّدات المُضاد، أي إنّها مسؤولةٌ عن ردود الفعل المناعيّة الأوليّة لجسم الإنسان، ويُشكّل هذا النوع من الأجسام المُضادّة ما نسبته عشرةٌ بالمائة من جميع الأجسام المُضادّة في جسم الإنسان، وتتميّز بأنّه يتمّ إنتاجها من قبل الخلايا البائيّة التي لم يتمّ تميّزها بعد في جهاز المناعية إلى أنواعٍ أخرى من الخلايا.
الجسم المُضاد من نوع IgE
يتميّز هذا النوع من الأجسام المُضادّة بأنّه يتواجد بكمياتٍ قليلةٍ جدًا في جسم الإنسان، كما إنّه مسؤولٌ عن ردود الفعل المناعيّة التحسسيّة، وردود الفعل المناعيّة تجاه الإصابة بالديدان الطُفيليّة، أي إنّ حدوث ارتفاعٍ في هذه الأجسام المُضادّة يعني إما وجود ردّ فعلٍ مناعيٍّ تحسسيّ أو الإصابة بأحد أنواع هذه الديديان المختلفة.
الجسم المُضاد من نوع IgA
يتواجد هذا النوع من الأجسام المُضادّة في كلٍ من اللّعاب، حليب الأم المُرضعة، الإفرازات المُخاطيّة التي تتواجد في كلٍ من الجهاز التنفسي والجهاز التناسليّ والجهاز البوليّ لدى الإنسان، حيث إنّ تواجده في كلٍ من هذه الإفرازات يعمل على حمايتها وحماية الأجهزة التي تتواجد فيها من الإصابة بأنواع العدوى المُمرِضة، إذ إنّه يعمل على القضاء على أيّ مادةٍ يتمّ تمييزها من قبله على أنّها جسمٌ غريب.
الجسم المُضاد IgD
يتميّز هذا النوع من الأجسام المُضادّة بأنّه يكوّن جزءً من الخلايا البائيّة في الجهاز المناعي، إذ إنّه يتواجد على سطح هذه الخلايا البائيّة التي لم يتمّ تميّزها بعد، وذلك لأنّ ارتباطها بهذه الخلايا يُحفّز تميّز هذه الخلايا إلى خلايا البلازما فور ارتباط أحد مولّدات المُضاد بالجسم المُضاد IgD، أي إنّه يساعد في معرفة مولّدات المُضاد ونضوج الخلايا البائيّة.
ما هي أهم الأسباب لارتفاع نسبة الأجسام المضادة؟
يتمّ عادةً إجراء فحصٍ لمستوى الأجسام المُضادّة المختلفة والمتعدّدة في جسم الإنسان، وذلك بهدف التأكد من وجود أحد الاضطرابات أو المشاكل الصحيّة وذلك بحسب توصية الطبيب المُختص والمعالج، إذ إنّ وجود أيّ ارتفاعٍ أو انخفاضٍ فيها قد يُعدّ دليلًا على وجود اضطرابٍ أو مشكلةٍ صحيّةٍ تستدعي المزيد من الاستقصاء الصحيّ، ومن أهم الأسباب التي قد تؤدّي إلى حدوث ارتفاعٍ في نسبة ومستوى الأجسام المُضادّة في الدم ما يأتي:[٤]
- الإصابة بأحد أنواع أمراض المناعة الذاتيّة، ومن الأمثل على هذه الأمراض الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، الإصابة بمرض الصدفيّة، الإصابة بمرض التهاب المفاصل الرثويّ، الإصابة بمرض اليسيلياك، وغيرها العديد من أنواع أمراض المناعة الذاتيّة المتعدّدة.[٥]
- الإصابة بمرض التهاب الكبد بأنواعه المختلفة.[٤]
- الإصابة بمرض تشمّع الكبد.[٤]
- الإصابة بأحد أنواع الالتهابات المزمنة.[٤]
- الإصابة بأحد أنواع العدوى الفيروسيّة مثل فيروس نقص المناعة البشريّة المكتسبة، والإصابة بالفيروس المُضخّم للخلايا.[٤]
- الإصابة بأحد أنواع العدوى البكتيريّة أو الطُفيليّة.[٤]
- الإصابة ببعض أنواع الأورام الحميدة أو الخبيثة مثل الإصابة بسرطان الخلايا اللمفاويّة من غير الهودجكنز.[٤]
ما هو تأثير ارتفاع نسبة الأجسام المضادة؟
بشكلٍ عام فإنّ ارتفاع مستويات هذه الأجسام المُضادة المُختلفة قد يعني وجود أحد الاضطرابات أو المشاكل الصحيّة التي يجب دراستها وتتبّعها بشكلٍ مكثّفٍ ودقيقٍ أكثر، وقد يؤدّي هذا الارتفاع المستمر والمزمن إلى حدوث تأثيراتٍ سلبيّةٍ على جهاز المناعة وأجهزة وأعضاء الجسم المختلفة، ومن أهم الأمثلة على التأثير الناتج عن ارتفاع مستوى الأجسام المُضادّة هو الارتفاع المزمن للجسم المُضاد من نوع IgE، حيث يُعدّ ذلك أحد الاضطرابات الوراثيّة التي تُعدّ نادرة الحدوث، فمثلًا، تتميّز الإصابة بهذا الاضطراب بوجود نقصٍ في مناعة الجسم، مما يؤدّي إلى ظهور أعراضٍ مختلفةٍ على أعضاء الجسم المختلفة ومن أهمّها حدوث:[٦]
- إكزيما الجلد.
- ظهور تقرّحاتٍ في الجلد.
- الإصابة بالتهاباتٍ وعدوى متكرّرةٍ في الجيوب الأنفيّة والجهاز التنفسيّ العلوي.
- حدوث نُدبٍ في منطقة التجويف الرئويّ.
- لإصابة بعدوى التهاب المهبل الناتج عن فطر الكانديدا بشكلٍ مستمرٍ ومتكررٍ.
- الإصابة بالعدوى المتكرّرة والفطريّة في أظافر اليدين والأقدام.
ما هو انخفاض الأجسام المضادة وما تأثيره؟
بشكلٍ عام فإنّ حدوث أيّ تغيّرٍ في مستويات الأجسام المُضادّة وخروجها عن الحد الطبيعيّ يُعدّ مؤشّرًا على وجود اضطرابٍ صحيّ، كما تم الحديث سابقًا، ونتيجةً لذلك فإنّ حدوث انخفاضٌ في مستويات أيّ من أنواع هذه الأجسام المُضادّة قد يكون ناتجًا عن وجود مشكلةٍ صحيّةٍ،[٧] وفي ما يأتي أهم أسباب انخفاض الأجسام المُضادّة وتأثيراتها:[٨]
انخفاض الجسم المُضاد من نوع IgA
قد يولد بعض الأشخاص ولديهم نقصٌ في هذا الجسم المُضاد، كما إنّ الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل اللوكيميا قد يكون سببًا في نقص هذه الأجسام المُضادّة، إضافةً إلى ذلك فإنّ حدوث تلفٍ في الكلى، أو الإصابة بتلفٍ في الأمعاء، قد يكون سببًا في ذلك، ويُعدّ انخفاض هذا الجسم المُضاد من الأمور والعوامل التي تُحفّز الإصابة بأمراض المناعة الذاتيّة.[٨]
انخفاض الجسم المُضاد من نوع IgM
تحدث الإصابة بنقصٍ في هذا الجسم المُضاد نتيجةً للإصابة بأورام النخاع الشوكيّ وهو ما يُسمّى بالورم النقويّ المُتعدّد، ونتيجةً للإصابة ببعض أنواع أورام الدم وتُسمّى أيضًا باللوكيميا، وبعض أنواع اضطرابات المناعة الوراثيّة، ويؤدّي نقصة إلى حدوث نقصٍ في ردود الفعل المناعيّة الأوليّة في جسم الإنسان.[٨]
انحفاض الجسم المُضاد من نوع IgE
قد يصيب بعض الأشخاص بعض أنواع الأمراض الوراثيّة التي قد تؤثّر على العضلات بأنواعها المُختلفة ومن أهم هذه الاضطرابات الوراثيّة هو اضطراب رنح التوسّع الشعيرات.[٨]
انخفاض الجسم المُضاد من نوع IgG
حيث إنّ هناك مجموعةٌ متعدّدةٌ وواسعةٌ من الأسباب التي قد تؤدّي إلى انخفاض مستويات هذا النوع من الأجسام المُضادّة، ومن أهم هذه الأسباب هو التقدّم في السن، الإصابة بنقصٍ في التغذية، استخدام بعض أنواع الأدوية والتي من أهمّها الأدوية الكيمياويّة التي تُستخدم لعلاج السرطان، واستخدام الأدوية التي تنتمي لفئة الكورتيزونات لفتراتٍ طويلة، كما إنّ الإصابة ببعض أنواع الفيروسات والعدوى مثل فيروس نقص المناعة البشريّة المُكتسبة قد يؤدّي إلى حدوث انخفاضٍ في مستويات هذا الجسم المُضاد، ويتسبّب حدوث هذا النقص في انخفاضٍ في مستوى ردود الفعل المناعيّة الثانويّة في جسم المناعة في الإنسان.[٩]
ما هي عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسيلة؟
بشكلٍ عام فإنّ هناك مجموعةٌ من العقاقير التي تمّ استحداثها مؤخرًا من قبل العلماء والمختصّين في مجال العلاج الطبيّ والتي تستند في عملها إلى طبيعة عمل الجهاز المناعي والأجسام المُضادّة، وفي ما يأتي سيتم مناقشة آلية عمل هذه الفئة واستخداماتها:[١٠]
ما هي آلية عمل عقاقير الأجسام المُضادّة أحاديّة النسيلة؟
تمّ استحداث هذه الفئة من الأدوية والعلاجات في المراحل المتقدّمة من العلاجات والأدوية، إذ إنّها تستند إلى طبيعة عمل الخلايا المناعيّة والأجسام المضادة في الجسم، حيث تمّ تصنيع بعض أنواع الأدوية التي تشبه بشكلٍ كبيرٍ تركيب الأجسام المُضادّة، بحيث تستهدف بشكلٍ خاص أحد أنواع مولّدات المُضاد التي تتسبّب في الإصابة ببعض الأمراض، حيث يتمّ استنساخ مئات الآلاف من هذه الأجسام المُضادّة مخبريًا وإعطائها للمريض بعد أن يتمّ تحديد مولّد المُضاد الذي تسبّب في حدوث هذا المرض، وتُعدّ هذه الطريقة في العلاج من الطرق التي تُستخدم لعلاج حالاتٍ متخصّصة ودقيقة من الاضطرابات والأمراض المختلفة.[١١]
بماذا يتم استخدام عقاقير الأجسام المُضادّة أحاديّة النسيلة؟
بعد الحديث عن آلية عمل هذه الفئة الحديثة من العقاقير وطرق العلاج فإنّه من المهم معرفته أنّ هذه الطريقة الحديثة في العلاج لا يُمكن استخدامها لعلاج أيّ نوعٍ من الأمراض، إذ إنّه يمكن استخدامها في الحالات التي يتمّ فيها معرفة مولّدات المُضاد التي تسبّببت في الإصابة بالمرض، وذلك لأنّ كلّ جسمٍ مضادٍ يُصنّع مخبريًا يستهدف نوعًا واحدًا من مولّدات المُضاد، ومن أهم الاستخدامات العلاجيّة لهذه الفئة من العلاجات ما يأتي:[١٠]
- علاج بعض أنواع السرطانات.
- علاج حالات الإصابة بالتهابات المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الرثويّ.
- علاج حالات الإصابة بمرض التصلّب اللويحيّ.
- علاج بعض أنواع الأمراض التي قد تصيب جهاز القلب والدوران والتي يتمّ فيها تحديد مولّدات المُضادات التي تسبّبت في إحداث المرض بشكلٍ دقيقٍ ومختص.
- علاج حالات الإصابة بمرض الذئبة الحمراء.
- علاج حالات الإصابة بمرض كرونز.
- علاج حالات الإصابة بمرض التهاب الأمعاء التقرّحيّ.
- علاج حالات الإصابة بمرض الصدفيّة خاصةً في مراحله المتقدّمة.
- للسيطرة على حالات رفض الجسم للأعضاء التي تمّ زراعتها فيه.
المراجع[+]
- ↑ "Antibody", www.britannica.com, Retrieved 2020-06-06. Edited.
- ↑ "IMMUNOGLOBULINS - STRUCTURE AND FUNCTION ", www.microbiologybook.org, Retrieved 2020-06-06. Edited.
- ↑ "Antibodies", courses.lumenlearning.com, Retrieved 2020-06-06. Edited.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ "Immunoglobulins Blood Test", medlineplus.gov, Retrieved 2020-06-06. Edited.
- ↑ "There are more than 100 Autoimmune Diseases", www.aarda.org, Retrieved 2020-06-06. Edited.
- ↑ "Hyper IgE Syndrome", primaryimmune.org, Retrieved 2020-06-07. Edited.
- ↑ "What Is an Immunoglobulin Test?", www.webmd.com, Retrieved 2020-06-07. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Immunoglobulins", www.uofmhealth.org, Retrieved 2020-06-07. Edited.
- ↑ "IgG Deficiencies", www.cedars-sinai.org, Retrieved 2020-06-07. Edited.
- ^ أ ب "Monoclonal Antibodies", www.medicinenet.com, Retrieved 2020-06-07. Edited.
- ↑ "Monoclonal Antibodies and Their Side Effects", www.cancer.org, Retrieved 2020-06-07. Edited.