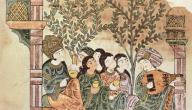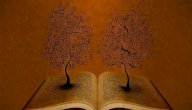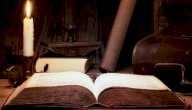محتويات
من أهم شعراء المدح في العصر العباسي؟
برز العديد من الشعراء في العصر العباسي الذين اتخذوا من شعرهم وسيلةً لكسب الهدايا والعطايا، ولعل من أبرز الأغراض الشعرية التي برزت في العصر العباسي هو المدح،[١] ومن أبرز شعراء المديح في العصر العباسي ما يأتي:
المتنبي
أبو الطيب أحمد بن حسين المتنبي (303هـ - 354هـ / 915م - 965م)،[٢] وُلد المتنبي في مدينة الكوفة في العراق، وفيها نشأ نشأته الأولى، وقد كان يتردّد ما بين البادية والحضر فأكسبه ذلك الصلابة من البدو والثقافة والعلم من الحضر، كان والده قد ردّده على القبائل، فساعد ذلك المتنبي في قول الشّعر.[٣]
يُذكر أنّه أخذ معظم علمه من مرافقة الورّاقين، وقد كان يمتهن المدح مدةً ليس بقليلة، إلّا أنّ هذا المديح لم يُلبِّ رغبته في الشهرة والرفعة، فلجأ نحو التمرّد وقد سُجن إثر ذلك، ثمّ أصبح يمدح قادة العرب، وقد وصل شعره في المدح إلى ما يُقارب نصف ديوانه.[٣]
مدح المتنبي مجموعةً من الأشخاص، منهم: سيف الدولة الحمداني، وبدر بن عمار، وآل اسحق التنوخي، وأبناء يحيى البحتري، وعبد الله بن خلكان، وشجاع الطائي، ومساور الرومي، والمغيث العجلي، وعلي بن محمد التيمي، والأمير محمد بن طغج وأبو العشائر الحمداني، كما تميّز شعره بعدّة سمات وأبرزها فيما يأتي:[٣]
- صدق القصائد وانعكاسها للواقع.
- دقة الوصف وأسلوب سلس واضح بعيدًا عن الغموض والتعقيد.
- عمق المعاني الشعرية وجزالة الألفاظ.
- الابتكار والبعد عن التقليد.
كما أنّ من أبرز الذين مدحهم المتنبي كان سيف الدولة الحمداني، إذ قال فيه قصيدةً بعد بناء مدينة مرعش سنة 341هـ:
فَدَيناكَ مِن رَبعٍ وَإِن زِدتَنا كَربا
- فَإِنَّكَ كُنتَ الشَرقَ لِلشَمسِ وَالغَربا
وَكَيفَ عَرَفنا رَسمَ مَن لَم يَدَع لَنا
- فُؤاداً لِعِرفانِ الرُسومِ وَلا لُبّا
نَزَلنا عَنِ الأَكوارِ نَمشي كَرامَةً
- لِمَن بانَ عَنهُ أَن نُلِمَّ بِهِ رَكبا
نَذُمُّ السَحابَ الغُرَّ في فِعلِها بِهِ
- وَنُعرِضُ عَنها كُلَّما طَلَعَت عَتبا
وَمَن صَحِبَ الدُنيا طَويلاً تَقَلَّبَت
- عَلى عَينِهِ حَتّى يَرى صِدقَها كِذبا
وَكَيفَ اِلتِذاذي بِالأَصائِلِ وَالضُحى
- إِذا لَم يَعُد ذاكَ النَسيمُ الَّذي هَبّا[٤]
البحتري
أبو عبادة الوليد بن عبيد الله (205هـ - 284هـ / 822م - 898م)، وُلد الشاعر البحتري في "منبج" بجوار حلب، وذلك في قرية تُدعى "زردفنه" وهناك أتقن قول الشعر، وما إن أتقن قول الشّعر حتّى اتّجه إلى العراق واتّصل ببلاط المتوكّل ولازمه، ولمّا حدثت فتنة المتوكّل التي قُتل فيها ووزيره الفتح عاد البحتري إلى بلده.[٥]
لكنّ ذلك لم يطل كثيرًا، فما لبث أن عاد من جديد إلى بغداد واستمرّ في مدح خلفائها، وقد بقيَ في العراق إلى نهاية حكم المعتمد ثمّ عاد إلى حلب واستقرّ في منبج، وتُوفي فيها عن عمر يُناهز الثمانين عامًا، وقد بلغ البحتري منزلةً عاليةً في العصر العباسي، واتّصل مع كبار الشّعراء.[٥]
أمّا عن قصائد مدحه فقد كانت كثيرةً، وممن مدحه البحتري من الخلفاء المتوكل، والمعتز، والمعتمد، والمهتدي، والمستعين، ومن غير الخلفاء مدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري وآله، وآل حميد الطوسي، وأحمد بن محمد الطّائي، وأبا صالح بن عمّار، ومحمد بن القمي، والخضر بن أحمد، وأبا صالح بن عمّار، ومحمد بن القمي، وغيرهم، واتسمت قصائده بعدّة سمات نذكر منها الآتي:[٥]
- جزالة الألفاظ وفصاحتها ووضوح معانيها.
- حسن اختيار الألفاظ فهي بعيدة عن الغموض والتعقيد.
- صدق العاطفة وبراعة الخيال والصور الفنية.
مما جاء في مدحه للفتح بن خاقان قوله:
أَقولُ لِرَكبٍ مُعتَفينَ تَدَرَّعوا
- عَلى عَجَلٍ قِطعاً مِنَ اللَيلِ غَيهَبا
رِدوا نائِلَ الفَتحِ بنِ خاقانَ إِنَّهُ
- أَعَمُّ نَدىً فيكُم وَأَقرَبُ مَطلَبا
هُوَ العارِضُ الثَجّاجُ أَخضَلَ جودُهُ
- وَطارَت حَواشي بَرقِهِ فَتَلَهَّبا
إِذا ما تَلَظّى في وَغى أَصعَقَ العِدى
- وَإِن فاضَ في أَكرومَةٍ غَمَرَ الرُبا
رَزينٌ إِذا ما القَومُ خَفَّت حُلومُهُم
- وَقورٌ إِذا ما حادِثُ الدَهرِ أَجلَبا
حَياتُكَ أَن يَلقاكَ بِالجودِ راضِياً
- وَمَوتُكَ أَن يَلقاكَ بِالبَأسِ مُغضَبا[٦]
أبو تمام
حبيب بن أوس الطائي (بين 188 و192هـ - بين 230 و231هـ / 804م - 845م)، وُلد أبو تمام في نهاية القرن الثاني الهجري في قرية تُدعى "جاسم" وتبعد هذه القرية عن دمشق ثمانية فراسخ يمين طريق طبريا، وكان يعمل في صغره عند حائك أو قزّاز في دمشق، وقد كان اسم والده "تدوس العطّار" وقد حُرّف إلى "أوس".[٧]
يُنسب الشّاعر إلى قبيلة "طيّئ" ولذا لُقّب بالطائي، وقد انتقل إلى مصر وجال جميع الأقطار العربية، وبقي كذلك إلى أن نبغ في قول الشّعر، فسمع بأمره المعتصم فأُتيَ به إلى سامرّاء، فبقي معه ومدحه، وكان وقتها أمير الشعراء، وقد اشتُهر أبو تمام بشعر المدح وأكثر فيه.[٧]
كان ممّن مدحهم أبو تمام القائد أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري وآله وهو قائد من طيّئ، ومدح آل وهب وزراء الدولة، وأمّا الخلفاء العباسيون الذين مدحهم فهُم المعتصم والمأمون والواثق، ومدح أيضًا القاضي أحمد بن أبي دؤاد، وخالد بن يزيد بن مزيد الشيباني، ومالك بن طوق التغلبي، ومحمد بن الهيثم بن شيانه، وآل حميد الطوشي، وغيرهم، وبرع أبو تمام في نظم الشعر، وتميّز شعره بسمات نذكر منها الآتي:[٧]
- دقة الأفكار وعمق المعاني.
- الواقعية وسعة الخيال.
- كثرة المحسنات البديعية.
من ذلك ما قاله في مدح قاضي الدولة العباسية أحمد بن أبي دؤاد يعتذر إليه قوله:
يا أَحمَدَ بنَ أَبي دُوادٍ حُطتَني
- بِحِياطَتي وَلَدَدتَني بِلُدودي
وَمَنَحتَني وُدّاً حَمَيتُ ذِمارَهُ
- وَذِمامَهُ مِن هِجرَةٍ وَصُدودِ
وَلَكَم عَدُوٍّ قالَ لي مُتَمَثِّلاً
- كَم مِن وَدودٍ لَيسَ بِالمَودودِ
أَضجَت إِيادٌ في مَعَدٍّ كُلِّها
- وَهُمُ إِيادُ بِنائِها المَمدودِ
تَنميكَ في قُلَلِ المَكارِمِ وَالعُلى
- زُهرٌ لِزُهرِ أُبُوَّةٍ وَجُدودِ
إِن كُنتُمُ عادِيَّ ذاكَ النَبعِ إِن
- نَسَبوا وَفَلقَةَ ذَلِكَ الجُلمودِ[٨]
أبو العتاهية
إسماعيل بن القاسم (130هـ - 211 أو213هـ / 748م - 828م)، لقد نشأ الشاعر أبو العتاهية في الكوفة، ولمّا تمكّن من قول الشّعر انتقل إلى بلاط الخلفاء، وقد كان ينتسب إلى عنزة بالولاء، فقد ورد أنّ ولاء أبي العتاهية من قبل أبيه لعنزة، ومن قبل أمه لبني زهرة، فقد ولد في عين تمر، وهي مدينة في العراق.[٩]
كان الشّاعر في بداية عهده كغيره من الشّعراء يمدح الخلفاء، فمدح المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافة المأمون ابن هارون الرشيد وكان قد بلغ الثمانين عامًا، أثنى عليه كثير من شعراء عصره ومنهم بشار بن برد، واتّسم شعر أبي العتاهية بكثير من السمات نذكر منها الآتي:[٩]
- الوضوح والبساطة.
- كثرة الموسيقا الداخلية من خلال الأوزان الشعرية.
- استخدام الصيغ الإنشائية.
من مدائحه ما جاء في مدح هارون الرشيد الخليفة العباسي الأشهر يوم أدَّبَ الروم وملكهم نقفور:[١٠]
إِمامَ الهُدى أَصبَحتَ بِالدينِ مَعنِيا
- وَأَصبَحتَ تَسقي كُلَّ مُستَمطِرٍ رِيّا
لَكَ اسمانِ شُقّا مِن رَشادٍ وَمِن هُداً
- فَأَنتَ الَّذي تُدعى رَشيداً وَمُهدِيّا
إِذا ما سَخِطتَ الشَيءَ كانَ مُسَخَّطاً
- وَإِن تَرضَ شَيئاً كانَ في الناسِ مَرضِيّا
بَسَطتَ لَنا شَرقاً وَغَرباً يَدَ العُلا
- فَأَوسَعتَ شَرقِيّاً وَأَوسَعتَ غَربِيّا
وَوَشَّيتَ وَجهَ الأَرضِ بِالجودِ وَالنَدى
- فَأَصبَحَ وَجهُ الأَرضِ بِالجودِ مَوشِيّا
وَأَنتَ أَميرَ المُؤمِنينَ فَتى التُقى
- نَشَرتَ مِنَ الإِحسانِ ما كانَ مَطوِيّا
قَضى اللَهُ أَن يَبقى لِهارونَ مُلكُهُ
- وَكانَ قَضاءُ اللَهِ في الخَلقِ مَقضِيّا
تَحَلَّبَتِ لدُنيا لِهارونَ بِالرِضا
- وَأَصبَحَ نَقفورٌ لِهارونَ ذِمِّيّا
مروان بن أبي حفصة
مروان بن أبي حفصة (105هـ - 182هـ / 723م - 798م)، يعود نسبه إلى يهود خراسان، فأصل جدّه منهم، وقد كان مولى لمروان بن الحكم فقد وهبه إليه عثمان بن عفّان -رضي الله عنه-، وقيل إنّه قد دافع عنه عندما حوصر وقُتل، فأُعتق بسبب ذلك الأمر.[١١]
كان شاعرًا متوسِّطًا بين شعراء عصره، وقد نشأ وترعرع في اليمامة حيثما كانت تقطن أسرته، يُعدّ من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في عصرين فقد نشأ في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي، إلّا أنّه لم يشتهر ولم يظهر اسمه إلّا في العصر العباسي، وقد استطاع أن يحصل على الكثير من الأموال بمدحياته.[١١]
من تلك المدحيات ما قاله في بني مطر:
بَنو مَطَرٍ يَومَ اللِقاءِ كَأَنَّهُم
- أُسودُ لَها في غيلِ خَفّانَ أَشبُلُ
هُمُ يَمنَعونَ الجارَ حَتّى كَأَنَّما
- لِجارِهِمُ بَينَ السِماكَينِ مَنزِلُ
بَهاليلُ في الإِسلامِ سادوا وَلَم يَكُن
- كَأَوَّلِهِم في الجاهِلِيَّةِ أَوَّلُ
هُمُ القَومُ إِن قالوا أًصابوا وإِن دُعوا
- أَجابوا وَإِن أَعطوا أَطابوا وَأَجزَلوا
وَما يَستَطيعُ الفاعِلونَ فِعالَهُم
- وَإِن أَحسَنوا في النائِباتِ وَأَجمَلوا
ثَلاثٌ بِأَمثالِ الجِبالِ حُباهُمُ
- وَأَحلامُهُم مِنها لَدى الوَزنِ أَثقَلُ
تَجَنَّبَ لا في القَولِ حَتّى كَأَنَّهُ
- حَرامٌ عَلَيهِ قَولُ لا حينَ تَسأَلُ
تَشابَهُ يَوماهُ عَلَينا فَأَشكَلا
- فَلا نَحنُ نَدري أَيُّ يَومَيهِ أَفضَلُ
أَيَومُ نَداهُ الغَمرُ أَم يَومُ بِأسِهِ
- وَما مِنهُما إِلّا أَغَرُّ مُحَجَّلُ[١٢]
أبو الشيص
محمد بن عبد الله بن رَزين الخزاعي (130هـ - 196هـ / 747م - 811 م)، غلب عليه لقب "أبو الشيص" وقد كان شعره متوسِّطًا؛ وذلك لأنّه جاء ما بين مسلم بن الوليد، وأشجع وأبي النواس، وكان ذلك سببًا جعله يرقد وينطفئ إلى حدّ ما.[١٣]
كانت معظم مدائحه إلى عقبة بن جعفر بن الأشعث أمير الرّقة، فمدحه بمعظم أشعاره، إذ قلّما يرى شعرًا لمدح غيره في أشعاره، وقد كان عقبة كريمًا جوادًا فأغناه بذكره عن ذكر سواه.[١٣]
ممّا جاء في مدائحه لعقبة قوله:
إِنَّ الأَمانَ مِنَ الزَمانِ وَرَيبهِ
- يا عُقبَ شَطّا بَحركِ الفيّاضِ
بَحرٌ يَلوذ المُعتَفونَ بِنَيله
- فَعم الجَداول مُترع الأَحواضِ
ثَبت المَقام إِذا التَوى بِعدّوه
- لَم يَخشَ مِن زَلل وَلا إِدحاضِ
غَيث تَوشَّحتِ الرياض عِهاده
- لَيثٌ يَطوفُ بِغابَةٍ وَغِياضِ
وَمشمّر لِلمَوتِ ذَيلَ قَميصِهِ
- قاني القَناة إِلى الرَدى خوّاضِ
لأَبي مُحَمَّد المُرَجّى راحَتَا
- مَلكٍ إِلى أَعلى العلى نهّاضِ[١٤]
علي بن يحيى المنجم
علي بن يحيى المنجم أبو الحسن (201هـ - 275هـ / 816م - 888م) يعود أصل الشاعر إلى فارس، وقد قيل إنّ جد أبيه يحيى واسمه "أبرسام البزرج" كان وزيرًا لأزدشير وصاحب أمره، وقد تعهّدهم المأمون وضمّهم إلى مجلسه، وبذلك بدأ نجم الأسرة يلمع في العصر العباسي.[١٥]
أُعجب به المتوكّل وقرّبه إليه؛ وذلك بسبب علمه الواسع الذي كان يتحلّى به، فقد كان عارفًا في جميع العلوم، وحمل كثيرًا من الأخبار والأسرار، ويُقال إنّه قد حصل بسببه على ما يُقارب ثلاثمئة ألف دينار تقريبًا، وصار نديم الخليفة ثم نادم الخلفاء الذين جاؤوا بعده حتى جاء عصر المعتمد.[١٥]
كان شاعرًا قال الشعر في كثير من الأمور والمناسبات، غير أنّ شعره لم يكن يعجبه لذلك فلم يكن يستشهد بشعر نفسه إلّا ما ندر، فقال كثيرًا من الأشعار التي جاءت في مدح الخلفاء والخلافة،[١٥] وممّا جاء في أشعاره المدحية قوله مادحًا المعتز عندما تسلَّمَ مقاليد الخلافة:
بَدا لابساً بُردَ النبّيِ محمّد
- بأحسنَ مِمّا أَقبلَ البَدرُ طالعا
سَمِيُّ النبيِّ وآبنُ وارثهِ الذي
- بهِ استشفعوا أَكرِم بذلكَ شافعا
فَلمّا عَلا الأعوادَ قامَ بخطبةٍ
- تَزيدُ هُدى مَن كانَ للحقِّ تابعا
وكلُّ عَزيزٍ خَشيةً منهُ خاشعٌ
- وأَنتَ تَراهُ خَشيةَ اللَهِ خاشعا[١٦]
أبو دلامة
زند بن الجون (161هـ / 778م)، مجهول سنة المولد، معروف سنة الوفاة، كان والده عبدًا لبني أسد فأعتقه رجل منهم، وقد عاصر أبو دلامة الدولتين الأموية والعباسية، ولم يكن له ذكر في الدولة الأموية إلا أنّه ظهر واشتهر في الدولة العباسية ولا سيّما بعد قرّبه من السفاح.[١٧]
كان يتمتع بالدّعابة التي جعلته خفيف الظل مقرّبًا من الناس، وقد كان أبو دلامة ممّن ظهر اسمهم بشكل واضح وجلي في الدّفاع عن الحكم العباسي ضد أعدائهم، فقد كان متمسّكًا أيّما تمسّك بالحكم العباسي، وقد قام أبو دلامة بمدح كثير من خلفاء الدولة، ومنهم السفاح، والمهدي، على أنّه أكثرَ من مديحه للسفاح حتى غار منه الخلفاء الذين جاؤوا بعده.[١٧]
مما قاله في مديح السفاح ورثائه:
أمسَيتَ بالأنبَارِ يا ابنَ مُحمَّدٍ
- لم تَستَطِع عَن غَيرِها تَحويلا
وَيلِي عَلَيكَ وَوَيلَ أهلي كُلِّهِم
- ويلاً وعَولاً في الحَيَاةِ طَويلا
فَلتَبكِيَنَّ لَكَ النِّسَاءُ بِعَبرَةٍ
- وليَبكِيَنَّ لك الرِّجالُ عَوِيلا
من مُجمِلٍ في الصَّبرِ عَنكَ فَلَم يَكُن
- صَبري عَلَيكَ غَدَاةَ بِنتَ جَميلا
يَجِدُون أبدَالاً بهِ وأنا امرُؤٌ
- لَو متُّ وَجداً ما وَجَدتُ بَدِيلا
هَلَكَ النَّدى إذ بِنتَ لابن مُحَمَّدٍ
- فَجَعَلتُهُ لَكَ في التُّرابِ عَدِيلا
إنّي سألتُ النَّاسَ بَعدَكَ كُلَّهُم
- فَوَجَدتُ أسمَحَ مَن سَألتُ بَخيلا
ألِشقوَتي أُخِّرتُ بَعدَكَ للّتي
- تَدَعُ العَزيزَ منَ الرِّجال ذَليلا
ألِشقوَتي أُخِّرتُ بَعدَكَ لِلَّذي
- يَدَعُ السمينَ مِنَ العِيال هَزيلا
فَلأَحلِفَنَّ يَمينَ حَقٍّ بَرَّةً
- باللهِ ما أُعطيتُ بَعدَكَ سُولا[١٨]
المراجع[+]
- ↑ "كتاب تاريخ الأدب العربي"، مكتبة نور، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2021. بتصرّف.
- ↑ الزركلي، الأعلام، صفحة 115. بتصرّف.
- ^ أ ب ت أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، صفحة 327 - 350. بتصرّف.
- ↑ "فديناك من ربع وإن زدتنا كربا"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب ت أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، صفحة 237 - 259. بتصرّف.
- ↑ "أجدك ما ينفك يسري لزينبا"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب ت أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، صفحة 185 - 220. بتصرّف.
- ↑ "أرأيت أي سوالف وخدود"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، صفحة 149 - 170. بتصرّف.
- ↑ "إمام الهدى أصبحت بالدين معنيا"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 298 - 311. بتصرّف.
- ↑ "كأن التي يوم الرحيل تعرضت"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 346 - 360. بتصرّف.
- ↑ "أبقى الزمان به ندوب عضاض"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب ت شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، صفحة 377 - 380. بتصرّف.
- ↑ "بدا لابسا برد النبي محمد"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.
- ^ أ ب شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، صفحة 290 - 297. بتصرّف.
- ↑ "أمسيت بالأنبار يا ابن محمد"، الديوان، اطّلع عليه بتاريخ 15/12/2021.